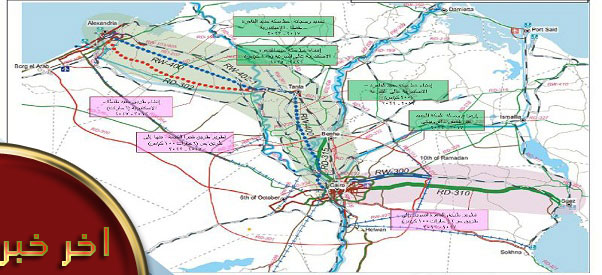بقلم: ستيفن م. والت
ترجمة: د. عاصم عبدالفتاح نبوي
ظلّت الولاياتُ المتحدة الأمريكية القوةَ المهيمنة على العالم منذ عام 1945م، وقد اجتهد قادتها لوقت طويل كي يحافظوا على هذا الوضع المتميّز. لقد أدركوا، كما فهم معظم الأمريكيين، أن الوجود في مركز الصدارة يجلب مكاسب مهمة.
ولقد أدى هذا إلى تقليل احتمالات أن تقوم الدول الأخرى بتهديد أمريكا أو مصالحها الحيوية بطريقة مباشرة. كما أدى وجود أمريكا في مركز الصدارة كذلك إلى القدرة على كبح جماح التنافس بين القوى الكبرى، مما أعطى واشنطن القدرة على صياغة وتشكيل توازنات القوى الإقليمية، وقد أسهم هذا الأمر بدوره في تعزيز الهدوء على الصعيد الدولي. واستتبع هذا الهدوء رخاءً شاملا؛ إذ شرع المستثمرون والتجار في العمل بمزيد من الثقة لمّا تضاءل خطرُ الحرب.
لقد مكّن وضع الصدارة هذا الولايات المتحدة من القدرة على العمل لأغراض إيجابية: تشجيع حقوق الإنسان والحدّ من انتشار أسلحة الدمار الشامل. ورغم أن الصدارة تؤدي إلى الشعور بالوحدة فوق القمة، فإن الأمريكيين اكتشفوا أن روعة المشهد من هناك كانت تَسْحَرُ الألباب.
مع ذلك فعندما تقف دولة ما وحيدة فوق ذروة الاقتدار والقوة، لا يكون هناك ملاذ ولا مصير سوى أن تبدأ بالانحطاط إلى أسفل. ولهذا فقد تكرر وقوع الأمريكيين فريسة للقلق بسبب إمكانية الانحطاط والتدهور – حتى عندما كان توقع حدوث ذلك بعيدا.
رغم كل الحبر الذي أريق في الكتابة عن ثبات أمريكا في مركز الصدارة، فإن أنصار هذا الرأي كانوا في الغالب يسألون الأسئلة الخطأ. فلم تكن القضية أبدا هي ما إذا كانت الولايات المتحدة قد بدأت تنهج نهج سقوط بريطانيا من مصاف الدول العظمى، أو أنها تعاني من شكل كارثي آخر من أشكال الانحطاط. لقد كان السؤال الحقيقي دائما هو ما إذا كان ما يمكن أن نسميه بـ "العصر الأمريكي" قد أشرف على نهايته. وعلى وجه التحديد، هل يمكن للولايات المتحدة أن تبقى القوة العالمية العظمى ولكن تصبح عاجزة عن أن تمارس نفس النفوذ الذي كانت تتمتع به في الماضي؟ إن كان هذا هو الوضع – وأنا أعتقد أن هذا هو الواقع الآن – فعلى واشنطن أن تبتكر استراتيجية عظيمة تمكنها من الاعتراف بالواقع الجديد مع بقائها قادرة على استخدام مصادر القوة الأمريكية الدائمة لخدمة الأهداف القومية.
وكانت أكثر عوامل القوة أهمية، هي تمتع الولايات المتحدة الملحوظ بالتميّز في العوامل الجغرافية والاقتصادية والبشرية. ولم تكن هناك قوة عظمى أخرى في نصف الكرة الغربي، ولهذا فلم يكن على الأمريكيين أن يقلقوا من احتمالات غزو خارجي. لقد كان لمناوئنا السوفييتي اقتصاد أصغر بكثير وتعوزه الكفاية التي يتمتع بها اقتصادنا الأمريكي. أما قوته العسكرية، والمتركزة في قواته الأرضية، فلم تقترب قط من مجال نفوذ القوة العسكرية الأمريكية العالمي وإمكاناتها.
أما مراكز القوة الرئيسة الأخرى فكانت كلها متموضعة على الأرض الأوروآسيوية أو قريبا منها – قريبة من الاتحاد السوفييتي وبعيدة عن الولايات المتحدة – مما جعل منافسين سابقين مثل ألمانيا واليابان يصبحون متلهفين على اللجوء إلى الولايات المتحدة طلبا للحماية من الدبّ الروسي. وهكذا فمع تقدم الحرب الباردة تمتعت الولايات المتحدة بمجموعة من الحلفاء الأقوياء المخلصين، بينما تزعّم الاتحاد السوفييتي بالمقارنة مجموعة من الشركاء الضعفاء المتخاذلين. وباختصار، حتى قبل أن ينهار الاتحاد السوفييتي، كان وضع أمريكا الكليّ مواتيا مثل وضع أية قوة عظمى في التاريخ الحديث.
فماذا فعلت الولايات المتحدة بكل تلك المميزات المثيرة للإعجاب؟ في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، أنشأت وتزعمت نظاما عالميا سياسيا وأمنيا واقتصاديا تقريبا في كل جزء من أجزاء الكرة الأرضية، فيما عدا ذلك الجزء الذي كان المجال المباشر لهيمنة الاتحاد السوفييتي وعملائه الشيوعيين. لم تكتف الولايات المتحدة فقط بحشر معظم العالم في مؤسسات كانت غالبا صناعة أمريكية (الأمم المتحدة UN، البنك الدولي WB، صندوق النقد الدوليIMF واتفاقية الجاتGATT )، ولكنها كذلك، ولعدة عقود، احتفظت لنفسها بالنفوذ الطاغي في كل هذه الترتيبات والمؤسسات.
لقد أدى مشروع "مارشال" إلى إعادة البناء الاقتصادي وإحياء الاقتصادات المحلية، كما ساعد التدخل الأمريكي غير المعلن في التأكد من أن الأحزاب الشيوعية لن تمسك بزمام السلطة، فيما حقّق حلف شمال الأطلسي (الناتو) السلام، وقام بردع الاتحاد السوفييتي وحيّد ضغطه العسكري. وكان منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء دائما محجوزا لضابط من الولايات المتحدة، ولم يحدث أبدا أن تبلورت مبادرة أمنية أوروبية ذات أهمية تذكر دون موافقة الولايات المتحدة ومساندتها.
(كان الاستثناء الرئيسى، الذي يدعم النظرية العامة، هو الحملة الإنجليزية-الفرنسية-الإسرائيلية الفاشلة على مصر أيام أزمة السويس 1956م، والتي كانت مغامرة جوبهت بالفشل بسبب وقوف الولايات المتحدة معارضة لها بشدة.) ولقد بنت الولايات المتحدة نظاما أمنيا يتمتع بنفس المتانة في آسيا من خلال علاقاتها الثنائية مع اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندة والفلبين والعديد من الدول الأخرى، كما دمجت كل دولة من هذه الدول في منظومة الاقتصاد العالمي التي كانت تحرريتها (ليبراليتها) آخذة في التزايد. وفي الشرق الأوسط، ساعدت واشنطن في قيام إسرائيل والدفاع عنها، ومع ذلك صاغت علاقات أمنية وثيقة مع المملكة العربية السعودية والأردن وشاه إيران والعديد من دول الخليج الصغيرة. واستمرت أمريكا في ممارسة الهيمنة على النصف الغربي من الكرة الأرضية، مستخدمة في ذلك أدوات مختلفة للإطاحة بالحكومات اليسارية في جواتيمالا وجمهورية الدومينيكان وشيلي ونيكاراجوا. أما أفريقيا، والتي لم تكن تعتبر مسرحا لصراع حيوي، فإن أمريكا فعلت بها ما هو كافٍ بالضبط لحماية اهتماماتها المتواضعة.
ولكي يكون كلامنا أكيدا، فإن الولايات المتحدة لم تمارس تحكّما شاملا في الأحداث في النظم الإقليمية العديدة التي أنشأتها. فهي لم تتمكن من الحيلولة دون وقوع الثورة في كوبا 1959م أو في إيران 1979م، كما أنها فشلت في منع فرنسا من الخروج من منظومة القيادة العسكرية المتكاملة لحلف الناتو في 1966م، ولم تتمكن كذلك من منع إسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان من حيازة الأسلحة النووية. لكن الولايات المتحدة احتفظت لنفسها بنفوذ هائل في كل من هذه المناطق، خصوصا في القضايا الرئيسية.
وأبعد من ذلك، وبرغم حدوث تحديات للموقف الأمريكي في بعض الأحيان – وكانت خسارة الحرب في فيتنام هي المثال الأبرز في هذا الصدد – فإن مكانة أمريكا على وجه العموم لم تكن أبدا في خطر. لقد ظل النظام الحليف للولايات المتحدة في آسيا متماسكا رغم هزيمتها في الهند الصينية، وخلال السبعينيات الميلادية (من القرن الفائت)، دخلت بكين في شراكة ضمنية مع واشنطن.
وعلاوة على ذلك، فإن الصين في النهاية نبذت الماركسية-اللينينية كعقيدة سياسية حاكمة، وتخلت بجدية عن مبدأ الثورة العالمية والتحقت طواعية عضوا بالمنظومات والهيئات التي سبق أن أنشأتها الولايات المتحدة. وبطريقة مماثلة، تحولت طهران إلى خصم مناوئ بمجرد سقوط الشاه ووصول نظام الملالي إلى سدّة الحكم، لكن وضع أمريكا العام في الشرق الأوسط لم يصبه أي اهتزاز. لقد استمر سريان النفط خارجا من الخليج الفارسي (هو الخليج العربي رغم أنف المؤلف – المترجم)، وتمتعت إسرائيل بالمزيد من الأمن والرخاء، ونَبَذَتْ في النهاية دولٌ كانت بالأمس من حلفاء موسكو الرئيسيين، مثل مصر، عهودها مع موسكو واصطفت إلى جوار الولايات المتحدة. وبالرغم من بعض النكسات العَرَضِيّة، فإن ملامح العصر الأمريكي بقيت راسخة في أماكنها.
ومن نافلة القول، أن نقول إنه من غير الطبيعي أن بلدا تعداد سكانه فقط 5% من عدد سكان العالم يكون قادرا على إنشاء نظم سياسية واقتصادية وأمنية تكون لصالحه في كل ركن من أغلب أركان المعمورة، وأن يكون كذلك قادرا على استدامة هذه النظم لعقود طويلة. ومع ذلك فإن ذلك كان في الحقيقة ما فعلته الولايات المتحدة من عام 1945م حتى عام 1990م. ولقد فعلت هذا بينما كانت تتمتع، ولنصف قرن متصل، بنمو اقتصادي ليس له نظير في التاريخ الحديث.
ولقد انهارت الامبراطورية السوفييتية حينئذ فجأة، تاركة الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم وحيد القطب. وطبقا لما قاله مستشار الأمن القومي الأسبق برنت سكوكروفت، فإن الولايات المتحدة وجدت نفسها "متَسَنّمَة بمفردها ذروة الاقتدار والقوة. ولقد كان ذلك وضعًا، وهو بالفعل كذلك، لا نظير له في التاريخ، وضعًا يتيح لنا فرصة نادرة جدًا لكي نشكل وجه العالم."
واغتنمت أمريكا تلك الفرصة، جالبة معظم دول حلف وارسو تحت عباءة حلف الناتو ومشجعة نشر اقتصاديات السوق والمؤسسات الديموقراطية في ربوع العالم الذي كان شيوعيا فيما سبق. ولقد كانت لحظة انتصارية – ذروة العصر الأمريكي – ولكن الألعاب النارية الاحتفالية أعمتنا عن رؤية الاتجاهات والمآزق الخطرة التي دفعت بالعصر الأمريكي إلى نهايته.
لقد شهد العقدان المنصرمان بزوغ مراكز قوى جديدة في عدد من المناطق الحيوية. والمثال الأكثر وضوحا على هذا هو الصين، والتي يعدّ معدّل نموّها الاقتصادي المتفجّر أكثر التطورات السياسية والاقتصادية أهميّة في عقود مرّت. لقد كان اقتصاد الولايات المتحدة هو الأقوى والأكبر تقريبا منذ عام 1900م، ولكن من المحتمل أن تتجاوز الصينُ أمريكا في إجمالي الناتج الاقتصادي في وقت لا يتعدّى عام 2025م.
وتنمو الميزانية العسكرية لبكين بمعدل تقريبي قدره 10% كل عام، وبالتالي فمن المحتمل أن تقوم بتحويل قدر أكبر من ثرواتها إلى أصول عسكرية في المستقبل. ولو حذت الصين حذو كل القوى العظمى التي سبقتها – بما في ذلك الولايات المتحدة – فإن تعريفها لدائرة اهتماماتها "الحيوية" سيتسع ويكبر مع تعاظم قوتها العسكرية – وستحاول استخدام عضلاتها النامية لحماية مناطق نفوذها الآخذة في الاتساع والتمدد. وإذا أخذنا في الاعتبار اعتمادها على المواد الخام المستوردة (خصوصا في مجال الطاقة) واعتماد نموها الاقتصادي على التصدير إلى الخارج، فإن الزعامة الصينية الحكيمة ستكون راغبة في التأكد من أنه ليس هناك من هو في وضع يمكّنه من الحيلولة بينها وبين الوصول إلى مصادر الخامات والأسواق التي يعتمد عليها مستقبل رخاء الصين واستقرارها السياسي.
وسوف يشجع هذا الوضع بكين على تحدّي الدور الحالي الذي تلعبه الولايات المتحدة في آسيا. وليس من العسير على الأمريكيين أن يتفهموا مثل هذه الطموحات، إذا عرفنا أن الولايات المتحدة قد سعت إلى إقصاء كل القوى الخارجية من جوارها منذ إعلان مبدأ "مونرو". وبمنطق مشابه، لابد أن تحس الصين بالضيق إذا حافظت واشنطن على شبكة تحالفاتها الآسيوية بالإضافة إلى وجودها العسكري الكبير في شرق آسيا والمحيط الهندي. وبمرور الوقت، ستحاول بكين إقناع الدول الآسيوية الأخرى بقطع علاقاتها مع أمريكا، وستقاوم واشنطن بالطبع هذه الجهود. إن تنافسا أمنيا شديدا لا بد وأن يتبع ذلك.
إن الترتيبات الأمنية التي شكلت العصر الأمريكي يجري الآن كذلك تقويضها ببزوغ قوى إقليمية هامة عديدة، ومن أهمها الهند وتركيا والبرازيل. ولقد نجحت كل دولة من هذه الدول في تحقيق نمو اقتصادي مذهل على مدار العقد الأخير، وأصبحت كل منها راغبة أكثر في تحديد مسار مستقبلها باستقلالية بعيدا عن رغبات واشنطن.
وليست هناك واحدة من هذه الدول على حافة أن تصبح قوة عظمى حقيقية – فإجمالي الناتج القومي البرازيلي مازال أقل من سُدُسِ نظيره في الولايات المتحدة، بينما اقتصاد كل من الهند وتركيا أقل حتى من ذلك – لكن كلا منها أصبحت ذات نفوذ متزايد في محيطها الإقليمي.
ويمكن أن يُلاحَظ انتشار القوة هذا في التوسع الحديث في مجموعة الدول الصناعية الكبرى من مجموعة الثماني دول G-8 إلى ما يسمى بمجموعة العشرينG-20، وهو اعتراف ضمنيّ بأن المؤسسات الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية يتزايد النظر إليها على أنها عتيقة وتحتاج إلى إصلاح.
وكل واحدة من هذه القوة الإقليمية الجديدة هي دولة ديموقراطية، مما يعني أن ساستها وزعماءها يهتمون بعناية بالرأي العام فيها. ونتيجة لذلك، فإن الولايات المتحدة لا يمكنها بعد الآن الاعتماد على العلاقات الدافئة المريحة مع النخب الحاكمة ذات الامتيازات أو الحكام العسكريين. فعندما يكون فقط 10-15% من المواطنين الأتراك هم الذين ينظرون إلى أمريكا بعين الاستحسان، فإنه يسهل علينا فهم لماذا رفضت أنقرة أن تسمحَ لواشنطن باستخدام الأراضي التركية لمهاجمة العراق في 2003م وفهم لماذا قلّصت تركيا علاقاتها السابقة الحميمة مع إسرائيل رغم الجهود الأمريكية الحثيثة لرأب الصّدع بينهما. ورغم أن معاداة الأمريكان أقل انتشارا في البرازيل والهند، إلا أن زعماءهم المنتخبين بطريقة ديموقراطية مع ذلك ليسوا مهتمين بتفضيل واشنطن في التعاملات.
إن نشوء قوى عالمية جديدة يذهب بالنظام العالمي ذي القطب المفرد إلى نهايته، وستكون النتيجة إما نظام تنافس صيني-أمريكي ثنائي القطببين، وإما نظام متعدد الأقطاب يتكون من عدة قوى عظيمة غير متكافئة. ومن المحتمل أن تظل الولايات المتحدة الدولة الأقوى، لكن سبْقها وريادتها قد تقلّصا – وما زال ذلك يتقلص أكثر وأكثر.
وبالطبع، فإن الهزيمتين المفجعتين في العراق وأفغانستان قد أسهمتا فقط في تعجيل محاق الهيمنة الأمريكية وأكدتا حدود قوتها.
إن الحرب على العراق وحدها ستظل عنوانا على تكلفة زادت على 3 تريليون (ثلاثة آلاف مليار) دولار أمريكي إذا تم حصر جميع التكاليف، والنتيجة النهائية المحتملة هي شبه ديموقراطية عراقية غير مستقرة، عدوّة لإسرائيل علنا، وستكون على الأقل منحازة إلى إيران. لقد كانت طهران في الحقيقة هي المستفيد الأكبر من هذه المغامرة غير المحسوبة، وليس هذا بالتأكيد ما كان يدور في خلد إدارة بوش عندما جرّت أمريكا إلى تلك الحرب.
إن الحملة الطويلة على أفغانستان مرشحةٌ أكثر لكي تكون نهايتها وبالا على أمريكا، حتى لو حاول القادة الأمريكيون أن يلفقوا أنها نصر من نوع ما. لقد استطاعت إدارة أوباما أن تطبق على عنق أسامة بن لادن، لكن المحاولات الطويلة والمكلفة للتخلص من طالبان وبناء دولة على الطراز الغربي في أفغانستان قد باءت بالفشل.
وعند هذه النقطة، فإن السؤال الوحيد المثير للاهتمام هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخرج من أفغانستان بسرعة أو على التراخي. وفي كلا التصورين لسير الأحداث، فإن مصير كابول سيتقرر في النهاية على يد الأفغان أنفسهم بعد أن تغادر الولايات المتحدة وحفنة حلفائها الذين يتناقص عددهم باستمرار.
وكما لو كان الفشل في أفغانستان ليس كافيا، فإن تورط الولايات المتحدة في وسط آسيا قد قوّض علاقاتها مع باكستان المسلحة نوويا، وقوّى المشاعر الخبيثة المضادة لكل ما هو أمريكي في ذلك البلد المضطرب. وإذا كان النصر يعرّف بأنه تحقيق أهدافك الرئيسة وإنهاء الحرب والخروج منها بأمن ورخاء معزّزين، فإنه يجب أن تُحْتسبَ نتيجة كل من هذين الصراعين (العراق وأفغانستان) هزيمةً باهظة التكاليف.
المؤلف هو أستاذ كرسي "روبرت ورينيه بيلفر" للشؤون الدولية في معهد كينيدي لعلوم الحكومة بجامعة هارفارد الأمريكية.
المصدر : جريدة الفتح




 0
التعليقات
0
التعليقات