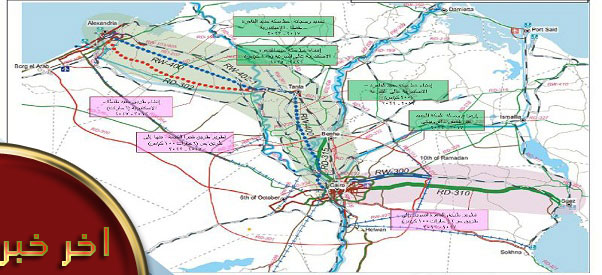كريستوفر ديفيدسون- فورين أفيرز
كذب المحللون السياسيون ولو صدقوا، والشيء الوحيد المؤكد في منطقة الشرق الأوسط هو أنه لا تحليلات مؤكدة.. ربما يكون هذا صحيحًا في معظم الأحيان، لكنه قد يكون مختلفًا تمامًا مع شخصٍ سبق أن توقع بدقة الكارثة الاقتصادية التي حلت بدبي في عام 2009 قبل حدوثها بأشهر، ولديه سجل حافل من الدراسات في تشخيص التغيرات الاجتماعية والسياسية التي تخوضها المنطقة بحنكة عالية.
إذا أضفنا إلى ذلك أنه أستاذ التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة “درم” البريطانية، والخبير السياسي والتاريخي والاقتصادي بشؤون دول الخليج العربي، الذي ألف كتبًا عديدة حول هذه البقعة التي تفوح منها رائحة النفط، منها: “خليج غير آمن”، “أبوظبي: النفط وما بعده”، “السلطة والسياسة في دول الخليج العربية”، “دبي: نجاح يولد ضعفًا”، “بعد الشيوخ: السقوط القادم لممالك الخليج”- إذا أضفنا ذلك إلى قدرته التنبؤاتيّة- يتضح أن أي تحذير مهما بلغت جرأته يصدر من رجل كهذا، يستحق التأمل.. والحذر.
منذ تأسيسها الحديث في منتصف القرن العشرين، والمملكة العربية السعودية، وخمس ممالك خليجية أصغر (البحرين، الكويت، عمان، قطر، الإمارات)، تحكمها أنظمة شديدة الاستبداد، ربما عفا عليها الزمن، ومع ذلك أظهر حكامها مرونة ملحوظة في مواجهة الصراعات الدامية في الدول المجاورة، وتنامي السكان في الداخل، وقوى التحديث في الخارج.
إحدى إستراتيجيات البقاء الأكثر وضوحًا كانت تعزيز العلاقات الأمنية مع القوى الغربية؛ جزئيًّا عبر السماح لأمريكا وفرنسا وبريطانيا ببناء قواعد ضخمة على ترابها، والإنفاق ببذخ على الأسلحة الغربية.
في المقابل، ساعدت هذه العسكرة باهظة الثمن جيلاً جديدًا من الحكام، يبدون أكثر ميلاً من أي وقت مضى لاستعداء إيران، وحتى الدول الخليجية الأخرى، لدرجة التسبب في أزمات دبلوماسية، أو التحريض على العنف، أو تدخل ملكية في الشأن الداخلي لملكية أخرى.
وبناء عليه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن دول الخليج، بطريقة أو بأخرى، لا تُقهَر؛ فبجانب التهديدات الداخلية القائمة، تواجه هذه الأنظمة أيضًا تهديدات خارجية؛ من الحكومات الغربية، وإيران، بل ومن بعضها البعض، وهو ما يفاقم صراعاتها المزمنة، وتناقضاتها الكامنة.
قواعد عسكرية في قلب الوطن
لطالما كان وجود قواعد عسكرية غربية كبيرة في شبه جزيرة العرب يمثل مشكلة لممالك الخليج؛ حيث يعتبر منتقديهم أن استضافة جيوش غير عربية وغير مسلمة إهانة للإسلام والسيادة الوطنية، وسوف يثير انتشارها مزيدًا من الانتقادات، بل قد تمثل نقطة وميض أخرى لحركات المعارضة في المنطقة.
ومن بين أكبر المنشآت الغربية في الخليج قاعدة العديد الجوية في قطر، والتي تدين بوجودها إلى الحاكم السابق للبلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتخدم أيضًا كمقر متقدم للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، والجناح الجوي للتدخل السريع في سلاح الجو الأمريكي، وقاعدة وكالة الاستخبارات المركزية CIA، ومجموعة من فرق القوات الخاصة الأمريكية. وتستضيف الجارة البحرين القيادة الوسطى لقوات البحرية الأمريكية، والأسطول الخامس الأمريكي بأكمله، بفريقٍ قوامه ستة آلاف، ومؤخرًا، خفضت أمريكا قواتها في الكويت، لكن قواعد المشاة الأربع لا تزال قائمة، بما في ذلك كامب باتريوت، التي يعتقد أنها تضم قرابة ثلاثة آلاف جندي أمريكي وقاعدتين جويتين.
وتخطط الولايات المتحدة لتوسيع وجودها العسكري الإقليمي في المستقبل القريب. وكما أعلنت القيادة المركزية مؤخرًا أن أمريكا ستسرسل أحدث أنظمتها المضادة للصواريخ لأربعة دول خليجية على الأقل (يُرَجِّح المحللون أنها: البحرين والكويت وقطر والإمارات)؛ بهدف تهدئة مخاوف حكام الخليج من الهجمات الصاروخية الإيرانية المحتملة.
وبالنظر إلى الناتج المحلي، يتضح أن دول الخليج أكبر مشترٍ للأسلحة في العالم، ما يجعل هذا الإنفاق، وفقًا لمعظم المقاييس، خارج نطاق السيطرة، وهو ما يمثل إشكالية مشابهة، وربما أكبر، من استضافة هذا العدد الكبير من القواعد العسكرية الغربية. ورغم أن الكثير من المعدات غير ملائمة لتعزيز القدرات الدفاعية، أو لا لزوم لها في عمليات حفظ السلام، إلا أن قادة الخليج يعتبرون هذه الصفقات ضرورية لحمايتهم، وهذا يشمل حتى دول الخليج الأكثر فقرًا، التي تكافح انخفاض الموارد والضغوط الاجتماعية الخطيرة.
وتتربع السعودية والإمارات على عرش أكبر الممالك شراءً للأسلحة؛ ففي عام 2009 وحده، ابتاعت الإمارات معدات عسكرية أمريكية بقرابة ثمانية مليارات دولار، ما جعلها أكبر عملاء الأسلحة في الولايات المتحدة ذاك العام، مقابل مشتريات سعودية بقرابة 3.3 مليار دولار. وفي ديسمبر 2011، أعلنت الولايات المتحدة أنها وضعت اللمسات الأخيرة على صفقة مقاتلات F-15 بقيمة 30 مليار دولار للقوات الجوية الملكية السعودية، وأفادت التقارير بأن الإمارات تعاقدت مع أنظمة الطيران العام أتوميكس للحصول على طائرات بريداتور بدون طيار؛ ما يجعلها أول مشترٍ أجنبي لهذه التقنية الأمريكية.
وفي الغرب لم تسلم هذه الصفقات من الانتقاد؛ فلطالما جادل اللوبي الإسرائيلي على سبيل المثال بأن بيع مثل هذه المعدات عالية الجودة لدول الخليج سوف يؤدي إلى تآكل التفوق النوعي إسرائيل في المنطقة. هذا إلى جانب صعوبة تبرير هذه الصفقات الضخمة لمواطني هذه الممالك. لكن في ظل التوترات الإقليمية القائمة، من المرجح أن تستمر زيادة الإنفاق، سواء على الدبابات والطائرات أو السفن الحربية.
مصالح مشتركة
أذابت نيران الخوف من إيران جليد العلاقات بين بعض دول الخليج وإسرائيل؛ فانفتحت قناة للتواصل بين قطر وأجهزة الأمن الإسرائيلية، ومورس الضغط على الملكيات للتعامل مع إيران، لكن بعض هذه الدول ترى في مواقفها المعارضة لإيران آلية ملائمة لاحتواء المعارضة الداخلية، وتشتيت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، والتلاعب بورقة التوترات الطائفية، وتسليط سيف “العمالة لإيران” زورًا على رقبة الحركات المعارضة لنزع شرعيتهم.
صحيح أنه حتى الآن، أحرزت هذه الإستراتيجية بعض النجاح المحدود، ولا يزال العديد من السلطات الغربية تقدم الدعم للأنظمة الملكية الخليجية خوفُا من أن يكون البديل: ثيوقراطية ثورية، على الطراز الإيراني، وحكومات معادية للغرب. لكن في المقابل، تمثل هذه المشاعر الشرسة المعادية لإيران خطرًا ربما يكون وجوديًّا؛ لأنها تقوض وضع ممالك الخليج المزمن كوسيط سلام محايد، وموزع لمساعدات التنمية الإقليمية، وتجعلها أهدافًا مشروعة في أي نزاع خليجي في الأفق، وهو ما لم يسمح به سابقًا آباء حكام الخليج، حتى حينما استولى الشاه على الجزر الإماراتية في عام 1971؛ اعترافًا بالمصالح الاقتصادية المشتركة، وتقديرًا لوزن المواطنين الإيرانيين المغتربين الموجودين في قلب العديد من هذه الممالك.
لكن ذلك أصبح تاريخًا الآن، في دول مثل البحرين والإمارات، والسعودية التي أظهرت تسريبات دبلوماسية في 2008 أنها حضت أمريكا على قطع رأس الأفعى، وطالبت في مناسبة أخرى بإنهاء قبضة حزب الله على جنوب لبنان عسكريًّا، وسعت للحصول على أسلحة نووية لمواجهة طهران.
وفي أوائل عام 2011، استفاد حكام البحرين من المشاعر المعادية لإيران كورقة ضد المعارضين المحليين. وحتى موقف أبو ظبي الذي يبدو مترددًا تجاه إيران، حسبما تُظهِر برقية من السفارة الأمريكية هناك عام 2006؛ ربما بسبب سياسات الحاكم السابق الأكثر اعتدالاً، لم يمنع مقربون من ولي العهد من المطالبة منذ عام 2007 بوضع مزيد من القوات الغربية في المنطقة لمواجهة الهيمنة الإيرانية، ولا ولي العهد من تحذير الولايات المتحدة بقوة في عام 2009 من استرضاء إيران، مشبهًا أحمدي نجاد بـ”هتلر”.
أما قطر، التي لعبت دورًا كوسيط سلام إقليمي، فكانت أكثر حذرًا في تصريحاتها العلنية بشأن إيران، وإن لخَّص رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، في اجتماع خاص عام 2009، علاقة بلاده مع إيران بقوله “إنهم يكذبون علينا، ونحن نكذب عليهم”. وتعود هذه الدبلوماسية القطرية المحسوبة إلى الموازنة شديدة الحساسية الكامنة في أنها: تستضيف أكبر منشآت عسكرية أمريكية، بينما تتقاسم أكبر مصدر للغاز- حقل الشمال- مع إيران.
عدو عدوي
أما الحمائمية تجاه إسرائيل فربما تكون أكثر خطورة من التشدد ضد إيران، فمنذ استقلالها ثبّتت دول الخليج قوانين تحتم على موظفي الحكومة ورجال الأعمال وحتى الأفراد المقيمين مقاطعة إسرائيل، لكن ظهور الفرص التجارية دفعت الإمارات أحيانًا لتجاهل قوانينها الخاصة بالمقاطعة؛ خاصة بعد الضغط الذي شهدته في أعقاب انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996، حتى إنها لم تكن تملك وسيلة لمنع وصول الوفد الإسرائيلي المشارك في الاجتماع السنوي للمنظمة الذي استضافته دبي في عام 2003، ولم تستطع الحول دون رفع علم إسرائيل أعلى قمة برج مركز التجرة العالمي في دبي.
وكما أشرنا سلفًا أذابت نيران الخوف من إيران جليد العلاقات بين بعض دول الخليج وإسرائيل، ما أسفر عن تدشين قناةٍ قائمة الآن للتواصل بين قطر وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وفي أواخر عام 2010، استضافت قطر وفدًا ضخمًا من كبار رجال الشرطة الإسرائيلية، من بينهم رئيس التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية وفرع المخابرات؛ ظاهريًّا كجزء من اجتماع للإنتربول، وصحيحٌ أنه لا توجد حتى الآن أدلة راسخة بشأن تنامي العلاقات الأمنية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، أو على الأقل وجود قبول سافر بها (كما هو حال البحرين وقطر)، إلا أن الشائعات المثارة حول التعاون السعودي الإسرائيلي، تنتشر منذ سنوات في أوساط الدوائر الدبلوماسية؛ وذلك بدافع وجود العدو المشترك.
وهذه السياسات الخليجية الجديدة تجاه إسرائيل تشكل خطرًا، لا سيما في ضوء الحقائق السياسية المحلية. فسكان الخليج، في معظمهم، معادون لإسرائيل ومؤيدون للفلسطينيين، ونشأت أجيال منهم على مشاهدة الانتفاضة الفلسطينية في التلفاز، ولا يزال تحرير فلسطين حلمًا مشتركًا بين شباب المنطقة. وهناك أيضًا تجمعات فلسطينية كبيرة داخل هذه الملكيات؛ وهم مواطنون خليجيون متجنسون، ولدوا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لكن بعضهم وصل إلى مناصب رسمية قوية.
الصراع الوراثة
وتصيب الضغوط التي تواجه دول الخليج المنطقة بتوتر شديد، في ظل خلافٍ بشأن الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل يهدد بالغليان، ويصل الصراع بين الممالك أحيانًا لمستوى مرير، لدرجة محاولة ملكية تغيير مسار الوراثة في ملكية أخرى، ففي أعقاب وفاة حاكمٍ، أو نشوبِ نزاعٍ صغيرٍ داخل ملكية، من الشائع الآن أن تتدخل الملكيات المجاورة؛ إما عبر الدعم الخفي لمرشح مفضل، أو في حالات أكثر تطرفًا، عبر رعاية انقلاب. وكثيرًا ما سمح فراغ السلطة الناجم عن ذلك للقوى الأجنبية بالتدخل أيضًا.
وأفضل مثال على انقلابات العصر الحديث، وما تبعها من تدخل أجنبي، هو ما حدث في إمارة رأس الخيمة شمال الإمارات العربية المتحدة، في عام 2003، حين عزل خالد بن صقر القاسمي، الذي أمضى سنوات طويلة في ولاية عهد الإمارة، وعين بدلاً منه أخيه الأصغر غير الشقيق الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وما تبع ذلك من انتقاداتٍ داخلية وصراعاتٍ عابرة للحدود.
ومن المرجح أن يتوقف مستقبل الخليج القريب على المزيد من هذه المحاولات الانقلابية والمناوئة للانقلابات، يعضد ذلك شيخوخة العديد من الممالك، وتضامن الفصائل القوية في العائلة المالكة المتنامية مع الخلفاء المتنافسين. وفي كل الأحوال، تتطور المنافسات الضروس، وبالنظر إلى الرهانات الباهظة، فإن مشاركة القوى الأجنبية أمر لا مفر منه.
في نهاية المطاف، قد تعاني كل الملكيات الخليجية من مثل هذه التدخلات، لأن قوة هذه الأنظمة لا يعدو أضعف حلقات سلسلتها، والنظام الملكي الهش الذي يذعن للتدخل الغربي، أو الإسرائيلي أو الإيراني، سوف يصبح بسهولة أول قطع الدومينو المترنحة؛ ما ينسف وهم مناعة دول الخليج، التي بنيت بشق الأنفس لتبقى متميزة عن الجمهوريات العربية المجاورة المتخبطة.




 0
التعليقات
0
التعليقات