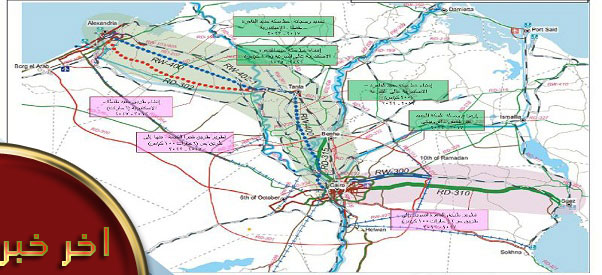هندس / عبد المنعم الشحات .. يكتب : "السلمي".. اتحاد الدويلات المصرية ذات النظام المدني
22-شوال-1432هـ 20-سبتمبر-2011
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فمن المتفق عليه أن الديكتاتورية هي أسوأ نظام حكم، ولكن ما هي أسوأ صورها؟
مِن وجهة نظري: إن الديكتاتورية التي تلبس ثوب مشاركة الشعب في الحكم (الشورى أو الديمقراطية) هي الأسوأ على الإطلاق؛ لأن "الديكتاتور المتخفي" يجيد التهرب من المسئولية، ويلقيها على الشعب الذي يزعم أنه قد استشاره!
ولهذه صور متعددة ألصقها في الذهن صورة "النظام السابق" الذي كان يأتي بأصحاب المصالح ليمثلوا الشعب شاء أم أبى!
تجلت آخر صورها في "مجلس عز" منزوع المعارضة، وقبله كان أستاذه "صفوت" يكتفي "بأغلبية مريحة" قادرة على تمرير أي قرار أو قانون! تاركًا بعض مقاعد للمعارضة تبدي بها شيئًا من آراء "الشعب الحقيقي" حتى إذا جدَّ الجَد، وحانت ساعة التصويت؛ لا يجد وقتها "فتحي سرور" أي عناء في عد غنماته؛ لأن "الأغلبية المريحة" تضمن له أن يقول: "موافقة".. هكذا دون عد!
وأما "القذافي": فاختار صورة أن يستشير الشعب كله "هيلا بيلا" عبر آليات نظن أنها سوف تبقى سرًا أبد الدهر؛ ليخرج بعدها بـ"قراراته الجماهيرية"!
وبالطبع لا بد لكل ديكتاتور من حدث تاريخي يمثل المشروعية التي يحكم بها حتى ولو تَخفى وراء شعار: "كلنا بنحبك يا ريس"، كما هو الحال للـ"ضربة الجوية الأولى" في حالة "مبارك"، و"قيادة الثورة الليبية" في حالة "القذافي".
ويبدو أن نمط الديكتاتور المتخفي قد أعجب كل مَن يتولى منصب "نائب رئيس وزراء مصر" بعد الثورة؛ سواء كان "الجمل" أم "السلمي"! وهكذا وبدون ضربة جوية أولى، ولا ثانية، خرج علينا الدكتور "علي السلمي" بوثيقة، قال: إنه استشار فيها منظمات المجتمع المدني، والنقابات، و.. و..
ولولا الملامة؛ لخرج علينا بالهتاف الذي كان أتباع الحزب الوطني المنحل يرددونه: "إن الأجنة في بطون أمهاتها تهتف لوثيقة علي السلمي".
وعندما اعترض المعترضون على الوثيقة الدستورية من حيث الشكل؛ لأنها ببساطة ليست دستورية! وسأل السائلون عن الحكمة من إقرارها دون انتظار للمسار الذي حدده الإعلان الدستوري الذي تولى هو بموجبه منصبه؛ برر العجلة أن البرلمان القادم سوف يسيطر عليه تيار واحد، ومِن ثَمَّ سوف يحتكرون كتابة الدستور!
ولا أدري: أين عشرات الأحزاب، ومئات النقابات، و.. و.. الذين قاربوا في زعمه أن يمثلوا إجماعًا وطنيًا؟!
الحاصل أن: الدكتور "علي السلمي" يُمثـِّل بتلك الوثيقة ديكتاتورية فشلت حتى في ارتداء "الثوب الديمقراطي"، فإذا استصحبنا أن هذه الديكتاتورية تتم في الدستور الذي لا ينبغي أن يأتي إلا باستفتاء شعبي عرفنا ما تستحقه هذه الوثيقة مِن وصف، إذن ففكرة هذه الوثيقة من حيث المبدأ فكرة بالغة السوء؛ بحيث إنهم لو عرضوا علينا أن نكتبها بأيدينا لرفضنا؛ لأننا باختصار نريد دستورًا سليمًا من الناحية الإجرائية.
طبعًا من حق أي قوة أو مجموعة قوى أن يصدروا وثيقة تمثلهم يخاطبون بها الرأي العام، وأما أن يتبنى "مجلس الوزراء" لوثيقة فضلاً أن يطالب "المجلس العسكري" بإصدار إعلان دستوري بها؛ فهذه هي الديكتاتورية بعينها!
ولكن السؤال: هل هناك ما هو أسوأ من فكرة الوثيقة؟
الإجابة: نعم. إن مضمون وثيقة الدكتور "السلمي" أسوأ بكثير من فكرتها، وسقطاتها أوضح من أن تعد.
ولكن سوف نكتفي هنا بأمرين:
الأول: النص على مدنية الدولة.
الثاني: تمزيق الدولة.
أما الأول: فنافح الدكتور "علي السلمي" عن مدنية الدولة "منافحة الأم عن ولدها"، ورغم ما قرره غير واحد -ومنهم غير الإسلاميين- على أن هذا مصطلح غير علمي، منهم: الدكتور "ضياء رشوان"، ورغم اعتراض الإسلاميين عليه على أساس أن كلمة المدنية إذا أضيفت إلى الدولة لا تعني إلا "الدولة اللا دينية"، لا سيما وأن هناك مَن يصرح بهذا، مثل: "أحمد عبد المعطي حجازي"!
ورغم أن "وثيقة الأزهر" وجدت حلاً عمليًا للمسألة حين نصت على أن دولة مصر: "دولة دستورية قانونية، وطنية حديثة، مرجعية التشريع فيها هي الشريعة الإسلامية". وهي صياغة كما ترى جمعت كل ما يحويه وصف المدنية من فضائل في ذات الوقت التي ابتعدت فيه عن شبهة اللفظ الذي يوهم اللا دينية، وهي طريقة شرعية علمنا الله إياها حين قال: (لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا) (البقرة:104), ورغم حضور الدكتور "السلمي" بنفسه مناقشات "وثيقة الأزهر"؛ إلا أنه ما زال يصر عليها، بل صرح أنها غير قابلة للمناقشة، ثم بعد ذلك يدعو الإسلاميين للمناقشة!
ثم جاءت الصيغة النهائية لتعلن صاعقة، وهو تراجع الدكتور عن تعبير "دولة مدنية" إلى تعبير "نظامها مدني"، وهي صياغة تستوجب منا أن نغلق كل هذه المناقشات الدستورية لنحتكم إلى مجمع اللغة العربية -"ولولا اعتبارات السن والوجاهة لقلت نعود إلى صفوف الدراسة المبكرة جدًا جدًا"- لنسأل أهل العربية ومدرسيها ودارسيها عن تلك "النكتة اللغوية"، وهذه "العطية السلطانية" التي يأمل معها "مولانا السلطان" أن نقبل الوثيقة بعد ما تفضل وتكرم، وجعل نظام الدولة مدنيًا بدلاً من أن يجعل الدولة ذاتها مدنيًا!
والذي فات "صاحب تلك النفحة"، و"صائغ تلك التحفة": أن الذي يُعنى بوضعه في الدستور، هو: "نظام الدولة"، فتعبير دولة مدنية إذا ورد في وثيقة دستورية فهو يكافئ تمامًا تعبير: "دولة نظامها مدني".
وأما أكبر أخطاء تلك الوثيقة على الإطلاق فهو: "إقحام وصف موحدة"، في قوله: "مصر دولة ديمقراطية موحدة"، وكان يمكن أن نحسن الظن ونقول: إن الخطأ هنا هو الخطأ العكسي تمامًا لخطأ تغيير تعبير "الدولة المدنية" إلى "الدولة التي نظامها مدني"، فنقول: إن معد الوثيقة قد يكون قد استحكمت العجمة من قلمه ولسانه؛ فلم يدر الفرق بين "الواحدة" و"الموحدة"، وأن بوسعنا أن نحمل القضيتين إلى مجمع اللغة العربية؛ فيُقضى بيننا وبين المحرر الأعجمي لوثيقة الدكتور "علي السلمي".
إلا أن تمام الوثيقة قد أفصح أن كاتبها قد أصابت العجمة قلبه وعقله، فظن أو تمنى أو.. أو.. ثم وجد طريقه إلى وثيقة دستورية أُريد لها أن تعد بليل، وأن تكتسب مشروعية الدساتير الشعبية؛ فمرر تلك الكلمة التي يبدو أنه يدرك معناها، ويعرف مغزاها، فقام بدسها في الوثيقة على أساس أن رافضي الوثيقة سوف تسحر أعينهم عبارة: "الدولة التي نظامها مدني"، ولن ينتبهوا إلى أن "السوس" في طريقه إلى الدولة ذاتها -حدودها الجغرافية- بعد ما ظن أنه قد أكل نظامها فأراده عالمانيًا، وقد أراده عامة سكانها إسلاميًا.
والدليل على ذلك: أن الوثيقة قد تولد عنها في صورتها الأخيرة وثيقة اختيار الهيئة التأسيسية فنزعت عن البرلمان المنتخب حق استكمال الدستور بعد ما نزعت الوثيقة الأم عنه حق وضع المبادئ الأساسية للدستور، وواضح أن صاحب فكرة الدولة الموحدة هو نفسه صاحب تلك الفقرة الإبليسية، والتي احتوت عليها الوثيقة الثانية، والتي تنص على أن: "الأماكن ذات الطبيعة الثقافية الخاصة يجب أن يكون لهم حضور وتمثيل في الهيئة التأسيسية". وقد حددت الوثيقة تلك الأماكن (سيناء - الوادي الجديد - للنوبة - حلايب وشلاتين) يعني الشرق والغرب والجنوب هي في حس واضع الوثيقة مناطق ذات طبيعة ثقافية خاصة، ولم يبق إلا أن يخرج علينا مَن يستنكر استئثار الشمال بوضوع الدستور ووظائف الدولة إلى آخره.. "يعني السودان شمال وجنوب وغرب".
وفي حدود علمنا أن أهم مقومات الثقافة هي: "الدين واللغة"، وهذه الأماكن يتكلم أهلها العربية و95% منهم بالإسلام كسائر أنحاء مصر، بل ربما كانت نسبة الإسلام فيهم تقارب المائة بالمائة، وحتى غير المسلمين فقد قالها "مكرم عبيد" قديمًا، و"رفيق حبيب" حديثًا: "أنا قبطي الديانة مسلم الثقافة".
ولا أدري ما الذي حدا بكاتب الوثيقة أن يعتبر أن هذه المناطق ذات طبيعة خاصة: هل لأنهم يرتدون الجلباب؟! فإن 70% من شعب مصر يرتديه، ونحن -بحمد الله- نرتدي كل ما أباح الله، والذي مِن أحبه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القميص الذي نسميه في اللغة الدارجة جلبابًا أو جلابية.
أم هل لأن لهم بعض العادات الخاصة في مناسباتهم الاجتماعية؟! فإن لكل محافظة في مصر بعض التميز في العادات بما لا يرقى قط إلى أن يُسمى تميزًا ثقافيًا، ولو كان هذا تميزًا؛ فدونك السكين فاعملها في الوطن مشرقًا ومغربًا، ومقبلاً ومدبرًا، حتى لا تدع فيه قرية ولا نجعًا إلا وعزلته عن الوطن الأم ثقافيًا، ثم بعد الثقافة تأتي السياسة التي ينبغي أن تكون مرآة للثقافة، وما لم يقتطع بالسياسة قطعته الأمم المتحدة التي تعمل على تمزيقنا!
فيا صاحب فكرة الدولة الموحدة: إن إقليم مصر عندما انضم إلى دولة الخلافة الموحدة احتفظ بحدوده كإقليم واحد داخل تلك الدولة الموحدة، وعندما جاءت "سايكس - بيكو" لتقسم المغرب العربي إلى دويلات: (المغرب - تونس - الجزائر)، وتقسم الشام إلى دويلات: (سوريا - لبنان - الأردن - فلسطين) لم تستطع أن تفعل مع مصر إلا أن فصلت عنها الأقاليم الموحدة معها، وآخرها: "السودان" لتترك مصر دولة واحدة عبر التاريخ.
والآن وقد أصبح العالم الغربي يريد نصرًا بلا حرب، ولكن فقط تمرير لفظ يَسير له دلالاته، وسابقة دستورية لها ما بعدها، يقتنع به مسئول في الدولة أو يدسها له مستشار أعجمي، أو خبير في شئون الدساتير المدنية، والمطلوب من القوى السياسية أن توقِّع؛ وإلا قيل -كما نسب في تصريح-: "إن الجميع موافق فيما عدا الإخوان، والسلفيون، والجماعة الإسلامية، والأحزاب ذات المرجعية الدينية، وحزب الوسط".
اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.



 0
التعليقات
0
التعليقات










.jpg)